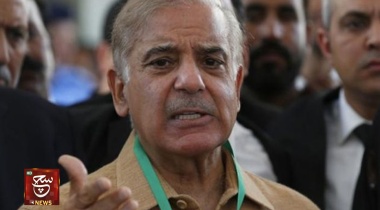فى ظل وضع دولى متشابك ومعقد، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة بكل تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط والحرب الروسية -الأوكرانية التى دخلت عامها الثالث، تبدو الحاجة ملحة لدراسة تأثير هذه التطورات على الوضع الدولى بشكل عام والتحالفات الإقليمية،
خاصة فى دولة مثل باكستان حيث مازالت العديد من المشكلات والأزمات تشكل المشهد السياسى والاجتماعى لشبه القارة الهندية، فإذا أضيف لذلك موقعها الجغرافى، حيث تحدها أفغانستان من الشمال وإيران من الغرب والصين من الشمال الشرقى وبحر العرب من الجنوب والهند من الغرب، سندرك على الفور الاهتمام الذى توليه إسلام آباد بدراسة تطورات الأوضاع الدولية وتأثيراتها المحتملة على الداخل الباكستانى بكل جوانبه.بالإضافة إلى انعكاساتها على قضايا آنية أخرى، مثل «الإسلاموفوبيا» وتغير المناخ ومستقبل العلوم والتكنولوجيا، وهى القضايا التى حرص معهد «الدراسات والأبحاث الاستراتيجية» فى باكستان على مناقشتها خلال ورشة العمل الدولية الرابعة، التى شارك فيها عدد كبير من الأكاديميين والدبلوماسيين والصحفيين من مختلف دول العالم، خاصة من الشباب أصحاب المبادرات المتميزة فى مجال ريادة الأعمال، وحاضر فيها نخبة متميزة ومختارة من الدبلوماسيين الباكستانيين السابقين والأكاديميين والمتخصصين فى العديد من المجالات ورموز الثقافة والفكر والرواد فى قطاعات الاستثمار وصناعة السينما وغيرهما.
فضلا عن عدد من الخبراء والأكاديميين من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، الذين شاركوا افتراضيا عن طرق تقنية «زووم»، سعيا لإيجاد حالة من الحوار والزخم حول نطاق واسع من القضايا المطروحة والتى شملت تطورات النظام الدولى فى الوقت الحالى وفرص وتحديات التعاون الإقليمى، لاسيما فى منطقة جنوب آسيا، والتوجهات العالمية الحديثة فى مجالات شتى، مثل حقوق الإنسان وريادة الأعمال وما أطلق عليه «فن وعلم تشكيل أسلوب السرد فى عصر ما بعد الحقيقة»، ومهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة الدولة، وإلى جوارها الإرث الحضارى والثقافى الباكستانى الثري.
وفى الوقت الذى تركزت فيها المحاضرات والمداخلات التى تلتها بشكل أساسى على القضايا المطروحة وتأثيرها الإقليمى على باكستان، احتلت القضية الفلسطينية وتداعياتها المؤسفة، خاصة على الصعيد الإنسانى جانبا كبيرا من المناقشات، بحيث يمكن القول إنها كانت حاضرة على طاولة المناقشة فى معظم جلسات ورشة العمل وحتى على مستوى الحوارات الخاصة، وسط إجماع من الحاضرين على أن ما يشهده قطاع غزة حاليا يشكل اختبارا قاسيا لمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وانتهاكا واضحا للقانون الدولى والإنسانى.
وكان من اللافت أيضا أنه فى الوقت الذى اتسمت فيه القضايا السابقة بوضوح المعالم المحددة لها، بدت قضية المعلومات فى «عصر ما بعد الحقيقة» متشعبة الملامح، والسبب ربما يكمن فى تعريف المصطلح الذى يشير إلى تأثير المعتقدات الشخصية والتوجهات العاطفية بشكل أكبر من الحقائق الموضوعية على الرأى العام، وهو ما يؤدى بالتبعية لانتشار المعلومات الخاطئة والمضللة بسهولة، وإلى مناخ تكون فيه الأولوية ليس للمنطق القائم على الأدلة الواضحة، بل للتوجهات العاطفية وطريقة السرد.
ومن هنا وبسبب تلاشى الحدود الفاصلة بين وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية وفى ظل هذا التداول الهائل للمعلومات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أصبح البحث عن الحقيقة مهمة صعبة فى رأى الكثيرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية مهمة ومحورية، يكون فيها المواطن عرضة لكم كبير من المعلومات التى يصعب التحقق من مدى صدقها.
فضلا عن أنه فى ظل السطوة الحالية لوسائل التواصل الاجتماعى كان التساؤل المطروح من قبل العديد من الحاضرين يتعلق بالدور الذى تلعبه هذه المنصات الجديدة وهل ستكون المسئولة عن تحديد السردية، أم أن السردية المطروحة هى التى ستحدد طريقة عمل هذه المنصات، خاصة أن هناك جدلا متواصلا حول «الخوارزميات» التى تحدد ما نشاهده، وما يمكن التلاعب به لصالح شخص أو تيار أو سردية معينة للأحداث، وهو ما يلقى بظلال كثيفة على حالة الشفافية فى ظل هذا الوضع الملتبس، لاسيما وأنه من وجهة نظر بعض المحاضرين، فإن الإعلام التقليدى يناقش القضايا القائمة بالفعل، بينما وسائل التواصل الاجتماعى يمكن أن تستخدم الأخبار لخلق حالة من الزخم والمتابعة، واستغلال ذلك لأغراض تجارية وهو ما غير المشهد تماما.
وهنا أشار المتحدثون إلى أن مصطلح عصر ما بعد الحقيقة ليس جديدا، حيث ظهر فى قاموس «أكسفورد» لأول مرة عام 2016 باعتباره كلمة العام، ولكن الجديد هو التطور الذى طرأ على المصطلح، فيما يتعلق بالحقائق الموضوعية التى يتم استخدامها لأغراض أخرى، وعلى سبيل المثال فإن الوصول لجمهور واسع يتطلب التأثير فيهم عاطفيا وليس عن طريق الحقائق، وبالتالى فى عصر يتم فيه إغراق الجميع بالمعلومات، تزداد صعوبة التفريق بين الحقائق والأكاذيب.
وهنا تأتى أهمية ما يطلق عليهم «gate keepers» أو حراس البوابة، الذين تتمثل وظيفتهم فى تمحيص وتدقيق الحقائق وإيصال أكثرها مصداقية للمتلقى، ومع ذلك وفى ظل التدفق الهائل للمعلومات أصبحت هذه الوظيفة حتى فى حالة وجودها أكثر صعوبة، ويرتبط بذلك ما يعرف بال «timeline» أو الجدول الزمنى الذى يعرض لكل شخص ما يريد أن يراه فقط بصورة غير مباشرة، فإذا شاهدت مقطع فيديو على سبيل المثال، أو قرأت خبرا ولو لثوان معدودة، فإن الشركات التى تدير هذه المواقع ستستخدم «الخوارزميات» لإغراق الشخص المستهدف بكم هائل من الأخبار والفيديوهات التى تتعلق بما شاهده فقط، وبالتالى وبشكل تلقائى لن يستطيع المرء أن يشاهد أو يقرأ أو يطلع على الآراء الأخرى، الأمر الذى سيغذى فى النهاية حالة الاستقطاب الموجودة فى الأصل بل سيزيدها حدة، ومن هنا تأتى التخوفات من أنه فى «عهد ما بعد الحقيقة» يمكن القول إننا سنصبح بشكل أو بآخر رهائن لدى الـ« timeline» الخاص بكل منا.
وهنا يطرح السؤال حول ما إذا كان المجتمع قد خسر المواجهة أمام عصر ما بعد الحقيقة، والإجابة التى طرحها المتخصصون تتعلق بقدرة كل مجتمع على مساندة والاهتمام بدور الإعلام الموجود والذى مازالت لديه القدرة على التدقيق فى الأخبار، حتى مع الأخذ فى الاعتبار أن الاستقطاب داخل المجتمع والانتماءات السياسية تلعب دورا لا يستهان به فى التأثير على أسلوب السرد.
ولكن مع كل هذه التحديات التى تحملها وسائل التواصل الاجتماعى، فإن هناك بعض الجوانب الإيجابية التى لايمكن إنكارها، منها على سبيل المثال أنها يمكن أن تقدم لنا جانبا آخر من القصة بديلا عن الجانب الذى تقدمه وسائل الإعلام التقليدية، والمثال الأبرز على ذلك الحرب الوحشية الدائرة فى غزة، حيث استطاعت وسائل التواصل الاجتماعى وعبر المشاهد المروعة التى وثقتها وأذاعتها فى بث حى أحيانا توضح حقيقة الحرب الإسرائيلية الوحشية فى غزة، وذلك فى مواجهة كبرى الصحف وشبكات التليفزيون العالمية التى تبنت وجهة النظر الإسرائيلية فقط، وهو ما أثر كثيرا فى توجهات العديد من المجتمعات الغربية خاصة بين أوساط الشباب وساهم فى انتشار الدعوات لإيقاف هذه الحرب، فضلا عما ذكره أحد المتحدثين من أن وسائل التواصل يمكن أن توصف بأنها تتسم بالديمقراطية، لأن كل شخص يستطيع أن ينشئ منصته الخاصة، وهناك حرية فى انضمام الآخرين لهذه المنصة أو لا، ومن الصحيح أنه يمكن أن تخلق حالة من الحقائق غير الكاملة، ولكنها على الجانب الآخر تخلق أيضا حالة من الحوار لا يمكن إنكارها.
وهنا طرح المتحدثون تساؤلا مشروعا عن مستقبل صناعة الإعلام فى ظل اتساع استخدامات «الذكاء الاصطناعى»، وإمكانية تدخله فى صناعة الأخبار على سبيل المثال، وهل يمكن تطبيق ما يمكن أن نطلق عليه «كود أخلاقى» لهذه الاستخدامات أم أنه أمر صعب، خاصة فى ظل التحديات المتعلقة باستخداماته، ومن بينها مثلا صعوبة التحقق من المعلومات أو من مصداقية الصورة، والدور الذى يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعى فى الترويج لأفكار معينة باعتبارها حقائق ثابتة.
ولمواجهة ذلك كان هناك توافق على ضرورة وجود معرفة واسعة بأخلاقيات العمل الإعلامى، وآليات للتحقق لمواجهة المعلومات المضللة، والتزام واضح بتقديم الحقائق الموضوعية للرأى العام ولصانع القرار، والعمل على نشر ثقافة الحوار الذى يشجع على وجود بيئة صحية لتبادل الأفكار والرؤى.